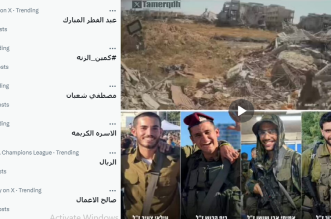من سخريات السياسة أن يندد نظام السيسي بالانقلاب العسكري في مالي، ويطالب بعودة الرئيس المنتخب وعودة الأوضاع الدستورية، وذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية!!
يعتقد نظام السيسي أن العالم نسي أنه أكبر انقلاب عسكري في أفريقيا في السنوات الأخيرة، ويبدو أنه نسي أنه انقلب على رئيس مدني منتخب انتخابا حرا أكمل بالكاد سنته الأولى في الحكم، ونسي أنه أطاح بالدستور وبكل المؤسسات المنتخبة الأخرى.. حقا إذا لم تستح فاصنع ما شئت!!
ومن حسن المقادير أن يتشابه حراك الماليين مع حراك المصريين في ثورة يناير 2011 في العديد من الوجوه، فكلا الشعبين انتفضا بشكل طبيعي ضد نظاميهما الحاكمين بسبب تراكم المظالم وتصاعد الفساد والاستبداد، وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير في كلا البلدين هي الانتخابات البرلمانية المزورة (في مصر 2010) وفي مالي في آذار/ مارس 2020، ومع نضوج الحراك الثوري في الدولتين، واقترابه من تحقيق هدفه تدخل العسكر هنا وهناك في المشهد النهائي "ليركبوا" الثورة، حيث نصحوا مبارك بالتخلي عن الحكم في مصر لصالحهم، بينما قبضوا على الرئيس إبراهيم كيتا، ورئيس وزرائه بوبو سيسي في مالي، بزعم أنه تحقيق لمطالب الشعب (رغم أن تحرك العسكر كان لأهداف فئوية).
حتى الخارطة السياسية التي قادت الحراك تشابهت إلى حد كبير في كلا البلدين، فحركة 5 يونيو التي قادت الحراك والانتفاضة في مالي ضمت رموزا إسلامية (سلفية وصوفية) وأخرى علمانية (يسارية وليبرالية) ومستقلة، كما ضمت نخبا ثقافية وفنية وعلمية، وقيادات مهنية وعمالية وطلابية ونسائية، وهو ما سبقهم إليه المصريون في ثورة يناير أيضا، حيث ماج ميدان التحرير بألوان الطيف السياسي المختلفة.
وإذا كان الشيخ القرضاوي قد وضع ثقله خلف ثورة يناير التي كان أحد آبائها المؤسسين (حيث تربى على كتبه وفكره وفقهه مئات الآلاف من الشباب المصري الذي شارك في الثورة)، كما أنه الذي أطلق صيحة نفير عام يوم معركة الجمل أنقذ بها الثورة، وكان خطيب جمعة النصر في ميدان التحرير، فإن الشيخ محمود ديكو، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى السابق، يعد النسخة المالية للشيخ القرضاوي، فهو الأب الروحي لحراك 5 يونيو، وخاصة بعد اعتقال زعيم المعارضة إسماعيل سيسي (قبل عدة أشهر). وقد تميز بالاعتدال الذي جعله مقبولا من الجميع، سواء كانوا صوفيين أو سلفيين، أو علمانيين، أو مسيحيين، وهذا ما وضعه في صدارة المشهد دون قصد منه، فكان بيته بيت الأمة، إليه يفد قادة الحراك الميدانيون للتشاور، وإليه يفد الرؤساء الأفارقة والسفراء الأجانب للوساطة، وبه يحتمي الشباب حين تطاردهم قوات الأمن التي قتلت 23 منهم خارج مسجده في العاصمة باماكو.
وإذا كان الشيخ يوسف القرضاوي قد حضر إلى ميدان التحرير خصيصا ليلقي خطبة جمعة النصر، والتي أرسل من خلالها العديد من رسائل الطمأنة لكل الفئات، فإن الشيخ محمود ديكو كان هو أيضا الخطيب الرئيسي في جمعة النصر في ميدان الاستقلال (21 آب/ أغسطس 2020)، ومن خلال كلمته وجه أيضا العديد من الرسائل السياسية المهمة لكل الأطراف في الداخل والخارج، وخاصة للعسكريين الذين قادوا الانقلاب، مؤكدا لهم أن الشعب يراقب تصرفاتهم، داعيا إياهم إلى أن يفوا بعهودهم.
وكما اتهم البعض الشيخ القرضاوي بأنه يسعى لأسلمة الثورة المصرية وأنه يستعيد مشهد الخميني (كما زعم الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل الذي لم يزر ميدان التحرير يوما رغم أن أنصاره كانوا ينتظرون وصوله طيلة الأيام، وقد رددت عليه شخصيا في حينه ونقل مقالي الشيخ القرضاوي في مذكراته)، فإن الشيخ ديكو تعرض للاتهام ذاته من حزب فرنسا وأنصار النظام المخلوع في الداخل والخارج، وهو ما نفاه الشيخ تماما، بل إنه أعلن عقب القبض على الرئيس إبراهيم كيتا ورئيس وزرائه بوبو سيسي أن مهمته انتهت، وأنه قد عاد إلى بيته ومسجده، ولن يشارك في أي عمل سياسي آخر، ليقطع عمليا الشكوك حول سعيه لدور سياسي في ظل الحكم الجديد. وربما كان خطابه يوم الجمعة هو آخر ظهور له في الميدان الذي لم يغب عنه طيلة الشهرين الماضيين.
لعل من مظاهر التشابه بين الحالتين المصرية والمالية أيضا ارتفاع سقف المطالب الشعبية مع تعنت النظام الحاكم في الاستجابة. فقد بدأت المظاهرات في مصر ضد القمع الأمني، وكانت المطالب تستهدف فقط رأس وزير الداخلية، لكن تأخر مبارك في الاستجابة رفع سقف المطالب حتى أنها لم تقبل لاحقا إقالة الحكومة جميعها وتعيين حكومة جديدة، وأصبح الهدف هو رأس مبارك نفسه، وهو ما تكرر بصورة أخرى في مالي، حيث كان المطلب البسيط هو تصحيح التزوير في انتخابات البرلمان والذي طال 30 مقعدا، ولكن عناد الرئيس رفع سقف المطالب تدريجيا ليصبح الهدف هو حل البرلمان كاملا وإقالة الحكومة ورئيسها، وإعادة تشكيل المحكمة الدستورية التي مارست التزوير، لكن الرئيس رفض إقالة وزيره الأول، وأعاد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، ما رفع السقف مجددا إلى المطالبة برأس الرئيس شخصيا، وهو ما تحقق وإن تم بتدخل عسكري.
تظهر سياسة الكيل بمكيالين جلية في تعامل القوى الكبرى والمؤسسات الدولية مع الانقلابين في مصر ومالي، فحين وقع انقلاب السيسي في الثالث من تموز/ يوليو 2013 لم يجتمع مجلس الأمن لإدانته، كما فعل مع انقلاب مالي، ولم يمارس الاتحاد الأوروبي ضغوطا على نظام السيسي كما فعل مع مالي، بل إنه أرسل مسئولة الشئون الخارجية آنذاك، كاترين أشتونـ للضغط على الرئيس مرسي لقبول الأمر الواقع، مدعية أن المعتصمين من أنصاره في ميدان رابعة لا يتجاوزون بضع آلاف!! كما لم تتحرك أي مجموعة إقليمية لفرض حصار على نظام السيسي كما فعلت مجموعة الإيكواس (المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا) على مالي، خوفا من انتقال العدوى إلى بلدانها الأخرى المؤهلة بشدة للانتفاضات.
التجمع الحاشد في جمعة النصر في ميدان الاستقلال يمثل رسالة لا تخطئها عين لقادة الانقلاب في الداخل للعودة إلى ثكناتهم، وللعالم الخارجي للتوقف عن ضغوطه لإعادة الرئيس المخلوع إلى موقعه. وكما ظهر جليا في كلمات المتحدثين (بما في ذلك كلمة المتحدث العسكري)، فإن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء.
ومع التأكيد على الرفض التام للانقلابات العسكرية سواء في مالي أو غيرها، فعلى الأرجح سيضطر عسكر مالي الجدد لترتيب انتقال آمن للسلطة إلى المدنيين عقب سلسلة الحوارات التي بدأوها بالفعل مع الأطراف الفاعلة، والتي ستشمل بالتأكيد قيادة حراك 5 يونيو، وهذا ما سيسهل توقف كل الضغوط الخارجية على مالي وعودة الحياة الطبيعية والديمقراطية للبلاد.
——–
نقلا عن "عربي21"