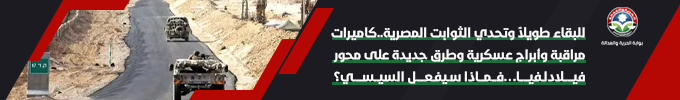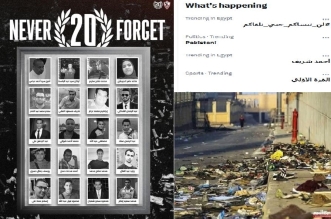رصدت دراسة بعنوان "علاقات مصر بدول حوض النيل في ظل تفاعلات القرن الإفريقي" نشرها موقع الشارع السياسي، أسباب فشل الانقلاب في التوصل من خلال الأطراف الدولية وعلاقتها الضعيفة بالقرن الأفريقي في الضغط على إثيوبيا بشأن حقوق مصر في نهر النيل.
وقالت إن "مصر بدأت تولي دول حوض النيل وشرق إفريقيا اهتماما لافتا، وأن السياسة المصرية تجاه القرن الإفريقي تظل تقوم بشكل أساسي على محاولة دفع القوى الإقليمية مثل الإمارات والسعودية، والدولية مثل الولايات المتحدة والصين روسيا، إلى الضغط على إثيوبيا لمراعاة مصالح مصر في مياه النيل".
فشل واضح
وقالت الدراسة إنه "من الواضح أن هذه السياسة غير ناجحة على الإطلاق، فالصين رغم علاقتها الوثيقة مع مصر، تعتبر إثيوبيا دولة مركزية بالنسبة لها في إفريقيا، وبكين لديها استثمارات ضخمة هناك، كما إنها تساهم في تمويل سد النهضة، وروسيا كما ظهر من مواقفها عند إثارة أزمة سد النهضة، في مجلس الأمن، مواقفها أقرب لإثيوبيا، كما أنها مع الصين تدافع عن قمع آبي أحمد للتيجراي في مواجهة الانتقادات الغربية".
وعن موقف الولايات المتحدة، أشارت الدراسة إلى أنه "بعد أن فرض الرئيس السابق دونالد ترامب عقوبات على إثيوبيا بعد رفضها التوقيع على الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بوساطة أمريكية في واشنطن، سارعت إدارة بايدن برفع هذه العقوبات، فور توليها السلطة، لتتحول إلى وسيط محايد مستعد لطرح الاقتراحات ونقل الأفكار دون ممارسة ضغوط في هذا الشأن، وسط مؤشرات على أن إدارة بايدن تخشى الضغط على إثيوبيا؛ حتى لا تذهب أكثر باتجاه الصين أو يؤدي الضغط إلى تفاقم الأزمات الداخلية الإثيوبية القائمة أصلا".
حبيس السمعة القديمة
وقالت الدراسة إن "من أبرز التحديات محليا، أن الفكر الاستراتيجي المصري عجز عن فهم متغيرات المحيط الإقليمي لمصر، وظل حبيس الأوهام القديمة التي تنظر إلى مصر بحسبانها قوة إقليمية مهيمنة؛ مع بقاء الأوضاع على ما هي عليه في دول حوض النيل، ويمكن الإشارة هنا إلى ثلاث تحولات كبرى".
وأشارت إلى أن التحولات مرتبطة بأعوام 99 و2020 ففي عام 1999 تم التوقيع على اتفاقية تجمع شرق إفريقيا (كينيا وأوغندة وتنزانيا ورواندا وبوروندي) ولا شك بأن هذه الحركة الإقليمية بدأت تطالب بإعادة النظر في الاتفاقيات الدولية الخاصة بنهر النيل، وهو ما يعني رفض النظام القانوني الحاكم لحوض النيل والموروث عن العهد الاستعماري.
وثانيها؛ استراتيجية السدود والمياه الإثيوبية والتي تبناها رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ميلس زيناوي، وتهدف إلى بناء أكثر من عشرين سدا ، على رأسها سد النهضة، بما يُحقق هدف تحويل إثيوبيا إلى دولة إقليمية كبرى مُصدِّرة للطاقة الكهرومائية.
وثالثها؛ التوقيع على مبادرة حوض النيل 1999 حيث تبنت جميع الدول النهرية -بما فيها مصر- رؤية جديدة، تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة، من خلال الاستخدام المنصف والعادل لمياه النيل، وقد استمرت العملية التفاوضية إلى أن تم التوصل إلى اتفاقية التعاون الإطاري عام 2010، التي وقعت عليها غالبية دول حوض النيل، وتستهدف تعزيز الإدارة التكاملية، والتنمية المستدامة، والاستخدام المُنسق لموارد مياه الحوض، بيد أن كلا من مصر والسودان رفضتا هذه الاتفاقية؛ لأنها لم تنص على الحقوق الطبيعية والتاريخية لدولتي المصب، كما أنها سحبت حق النقض الذي تمتعت به مصر -تاريخيا- فيما يتعلق بالمشروعات المائية التي تقوم بها دول أعالي النيل.
محددات العلاقات
وعن علاقة مصر بدول حوض النيل في ظل تفاعلات القرن الإفريقي، طرحت الدراسة 4 محددات تتعلق أيضل بالتحديات التي تواجه تلك العلاقات، وإمكانيات التعاون مع تلك الدول.
وأشارت إلى أن أولا مُحددات العلاقات المصرية بدول حوض النيل، وأن هذه المحددات مائية وأمنية وسياسية واقتصادية،
وأن المُحدد المائي، هدفه استمالة مواقف دول حوض النيل في تلك الأزمة وإقناعها بأحقية المخاوف المصرية من تداعيات السد على حقوقها المائية، والسعي إلى تحييد موقف بعض دول الإقليم التي لا تدعم الموقف المصري في الأزمة.
أما المُحدد الأمني، قالت إن "أبعاد الأمن القومي المصري بمفهومه العسكري والأمني الضيق يرتبط بالسودان تحديدا كونه يُشكل حدود مصر الجنوبية، وكذلك بمفهومه الواسع؛ فالسودان رغم كونه دولة الممر لمصر بنسبة 100 % إلا أنه لا يُشكل أي تهديد مائي لها نظرا لوجود اتفاقية العام 1959 المائية والتي تُحدد حصة كل منهما".
وعن المُحدد السياسي، لفتت إلى تعاون دول القرن الأفريقي (إثيوبيا وإريتريا والسودان مع بعض دول الخليج وبعض دول القرن الإفريقي الأخرى، بالإضافة إلى تنامي نشاط التنظيمات الإرهابية التي دفعت القوى الإقليمية والدولية إلى تعزيز حضورها في الإقليم عبر عدة آليات، من بينها، نشر القواعد العسكرية، والاستثمار في سدود دول حوض النيل وموانئ الساحل الشرقي الإفريقي وهو ما أشارت إلى أنه يترتب عليه خلق حالة من التجاذبات السياسية والتوترات الأمنية، وتُهدد تلك التغيرات أمن واستقرار المنطقة، كما أنها تؤثر بشكل أو بآخر على المصالح المصرية هناك".
تحديات التعاون
وأشارت إلى أن أبرز التحديات بين مصر ودول حوض النيل؛ الخلافات المُتعلقة بالمياه، حيث عدم وجود تنظيم حقيقي حتى الآن بين دول الحوض يحسم عملية توزيع المياه واستغلالها، لاسيما وأن إثيوبيا التي تسهم وحدها بأكثر من 80% من جملة إيرادات النهر، تُمثل عقبة حتى الآن أمام قيام تنظيم قانوني حقيقي يجمع كل دول الحوض"، وتعرض إثيوبيا نفسها كفاعل إقليمي قوي في منطقتي حوض النيل والقرن الإفريقي، إضافة لوجود تنافس حقيقي بين دول حوض النيل حول إنتاج أنواع معينة من المحاصيل التي تحتاج إلى كميات غزيرة من المياه، مشيرة إلى أن التحدي الثالث؛ العديد من الصراعات والعداوات والاقتتال الداخلي في الكونغو الديموقراطية وأوغندا.
لاعبون مع الأقوى
وقالت الدراسة إنه "لا يوجد للقاهرة سوى نفوذ ضئيل بدول حوض النيل، الأمر الذي دفعها لمحاولة تشكيل سلسلة تحالفات في المنطقة، إضافة إلى محاولة اكتساب القوى الدولية والإقليمية لصفها في نزاعها والسودان مع إثيوبيا حول مياه النيل".
وأوضحت أن محاولة بسط النفوذ من خلال إريتريا وجنوب السودان كان رهانا فاشلا ، وأن السيسي في ظل نفوذ حليفته الإمارات في أسمرا الذي وصل لتأسيس قاعدة عسكرية إماراتية هناك، ولكن هذا الرهان سرعان ما فشل إثر تحالف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي في مواجهة عدوهم المشترك جبهة تحرير تيجراي.
وبالنسبة لجنوب السودان؛ قالت إن "جنوب السودان محور لتنافس مصري- إثيوبي قديم عززه نزاع سد النهضة، وبين القاهرة وجوبا تعاون واسع في المجالات كافة، حيث أخذت مصر على عاتقها دعم الدولة الوليدة منذ استقلالها عن السودان عام 2011، كما اعتبرت جوبا مخاوف الخرطوم من الملء الثاني الأحادي لسد النهضة الإثيوبي، مشروعة، خلال لقاء مشترك بين الجانبين".
وخلصت إلى أن "جنوب السودان دولة ضعيفة وصغيرة ومنقسمة حصلت على استقلالها للتو، ولديها مشاكل داخلية كبيرة، وبالتالي على الأرجح فإنها تحاول الاستفادة من التلاعب بين الدول الكبيرة في المنطقة، لاسيما مصر وإثيوبيا".
نفوذ غير مؤثر
وعن أوغندا ورواندا وبوروندي والكونغو قالت الدراسة إن "القاهرة تتبع في الفترة الأخيرة سياسة احتواء لإثيوبيا في دول الجوار، وأشارت إلى أن مواقف الكونغو تبدو أكثر تفهما لمصالح دولتي المصب مصر والسودان أكثر من أغلب دول المنابع الأخرى، ويبدو هذا الموقف قديما وسابقا في الأزمة الأخيرة وما تبعها من تحركات مصرية".
واستدركت أنه "تظل الكونغو دولة غير منخرطة بقوة في أحداث القرن الإفريقي، وهي رغم مواردها الهائلة، دولة خارجة من أزمات وحروب أهلية، بحيث كانت تستحق لفترة وصف “رجل إفريقيا المريض” وهي ليست لديها حدود مباشرة مع إثيوبيا، ومن ثمَّ فإن تأثير مواقفها معنوي، خصوصا مع توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي".
وعن تنزانيا وكينيا، أبانت الورقة أن علاقات مصر بتنزانيا، برزت عندما أسندت الحكومة التنزانية في ديسمبر 2018، عقد إنشاء المشروع إلى شركات مصرية بتكلفة 2.9 مليار دولار، وهو يُعد مشروعا قوميا عملاقا، تنفذه شركتا المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، تحت إشراف الحكومة المصرية، وفي نوفمبر 2020، أُعلن أن الشركات المصرية استطاعت إنهاء أعمال الحفر لسد جيوليوس، ويُعد هذا المشروع هو الأول من نوعه لمصر في الخارج.
أما كينيا؛ فأشارت إلى أن لها حدودا مباشرة مع إثيوبيا، ولم يُنشر أن مصر وقعت اتفاقات مماثلة لاتفاقياتها مع بوروندي وأوغندا مع كينيا، ولكن هناك خلافات كينية- إثيوبية متعددة الأوجه".