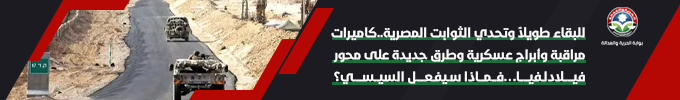بقلم إيمان الجارحى
لم يكن عامَا الطوفان عامَي مذابح في غزة فقط، بل شكّلا ذروة مسار ممتد من إدارة الصراع في الإقليم، مسار لم تُستهدف فيه فلسطين وحدها، بل امتدت ارتداداته إلى اليمن والسودان والصومال، بوصفها ساحات وظيفية متصلة ببنية واحدة. ما جرى لم يكن مواقف لحظية أو تفاعلات عشوائية، بل نتيجة نمط متكرر تُدار فيه الأزمات بهدف إبقاء الإقليم في حالة سيولة قابلة للضبط، لا للوصول إلى حسم سياسي.
في هذا السياق، يظهر أن ما يتكرر عبر ساحات مختلفة ليس الحدث ذاته، بل آلية التدخل: إعادة إنتاج الأزمة بأدوات متشابهة، مع اختلاف السياق المحلي، بما يشير إلى منطق إدارة واحد لا إلى استجابات منفصلة. وفي قلب هذه السيولة، تتشكل عقدة مركزية تتجمع عندها ارتدادات الأطراف، هي مصر، بوصفها نقطة التقاء الجغرافيا والزمن والاقتصاد والأمن.
في هذا الإطار، يصبح التمييز بين إدارة الحروب وإدارة الصراعات ضرورة تحليلية. فإدارة الحروب تقوم على المواجهة المباشرة والنهاية الواضحة، أما إدارة الصراعات فتقوم على إطالة الزمن، وتوزيع التوتر، وإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية على نحو يمنع أي طرف من تحقيق اختراق حاسم. هذا النمط من الإدارة لا يعمل عبر الانفجار، بل عبر التآكل البطيء، ويهدف إلى تعطيل لحظات التحول لا مواجهتها.
وعندما تصبح لحظة التحول محتملة في مركز بحجم مصر، تتحول إدارة الصراع إلى أداة لمنع الانتقال، لا لإنتاج تسوية. ومن هنا، يصبح تفكيك البنى الإقليمية الصلبة شرطا لازما لاستمرار هذا النمط من الإدارة، بحيث لا تتبلور مراكز قادرة على كسر منطق الإطالة والتأجيل.
عندما تصبح لحظة التحول محتملة في مركز بحجم مصر، تتحول إدارة الصراع إلى أداة لمنع الانتقال، لا لإنتاج تسوية
تفكيك المحاور وإعادة ضبط الإقليم
تعمل الولايات المتحدة في المرحلة الراهنة على تفكيك المحاور والتكتلات الإقليمية، لا عبر إسقاطها دفعة واحدة، بل عبر تفريغها من مضمونها الوظيفي. لا يعني ذلك غياب التحالفات، بل إعادة تشكيلها في صورة مرنة، مؤقتة وقابلة للتبديل، بما يمنع تحوّل أي محور إلى كتلة صلبة قادرة على فرض معادلات مستقلة.
في هذا السياق، لا تُدار الخصومات والتحالفات بوصفها ثوابت أخلاقية أو أيديولوجية، بل بوصفها أدوات مرحلية. غير أن منح مساحات لقوى معينة لا يعكس تحالفا استراتيجيا معها، فإتاحة المجال لتوغّل إيران في العراق واليمن ولبنان وسوريا لا تمثل اتفاقا مع الولايات المتحدة، بل تؤدي عمليا إلى تعميق عدم الاستقرار، وإحداث شروخ داخل المجتمعات، وإبقاء الصراع دون نقطة ارتكاز جامعة. وهو مسار معروف في دوائر القرار، حتى دون إعلان رسمي.
تُستخدم هذه السيولة المقصودة لمنع تشكّل مركز إقليمي متماسك، ولإبقاء الأطراف في حالة إنهاك متبادل، بما يجعل الجميع محتاجا إلى إدارة خارجية للصراع. وكلما تآكلت الأطراف، ارتفعت حساسية الممرات التي تربط الإقليم بالعالم، وعلى رأسها خطوط البحر الأحمر وباب المندب وقناة السويس.
صوماليلاند، اليمن، السودان: جغرافيا التفكيك الوظيفي
يشكّل الصومال واليمن والسودان ثلاث حلقات متصلة في هذه الهندسة. فهي ليست ساحات منفصلة، بل نقاط ارتكاز على خطوط الملاحة العالمية، وباب المندب، والبحر الأحمر، والقرن الأفريقي، وأي اضطراب في هذه المناطق ينعكس مباشرة على قناة السويس، وعلى مركز الثقل المصري.
في هذا السياق، لا يمكن قراءة الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال كحدث منفصل، بل كجزء من إعادة ترتيب المجال البحري والأمني في القرن الأفريقي. يفتح هذا الاعتراف المجال لتواجد استخباراتي وأمني دائم على الضفة المقابلة لليمن، ويضيف عنصر ضغط جديدا على الممرات البحرية، ويعيد توزيع الأدوار في البحر الأحمر بما لا يسمح لمصر بالتحرك خارج منظومة الضبط.
وبهذا يصبح البحر الأحمر ليس ساحة أحداث، بل أداة ضبط تُقاس فعاليتها بمدى قدرتها على إعادة توجيه الضغط نحو المركز المصري عبر الممرات والتجارة والأمن.
ما بعد أكتوبر: تحييد الجغرافيا ومنع الحسم
إذا كانت حرب أكتوبر 1973 قد مثّلت لحظة استخدام الجغرافيا لكسر الهيمنة وفرض معادلة سيادية، فإن المرحلة الراهنة تقوم على تحييد الجغرافيا ومنع استخدامها للحسم. لم تعد الجغرافيا أداة للتحرير، بل مجالا للإدارة، يُمنع فيه أي تحوّل جذري.
في هذا السياق، يتحول البحر الأحمر من ساحة صراع مفتوح إلى مجال أمني مُدار، وتتحول قناة السويس من ورقة سيادية إلى مرفق دولي حساس يُطلب تأمينه لا توظيفه. وتُعاد إدماج مصر داخل منظومة منع الانهيار، لا بوصفها طرفا في إعادة التشكيل، بل بوصفها مركزا يُمنع تحوله.
وعند هذه النقطة، يتصل ضبط الممرات بضبط فلسطين، لأن هندسة الاستقرار في البحر الأحمر لا تنفصل عن هندسة التوتر في قلب الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
إسرائيل كضرورة وظيفية للنظام الدولي
تظهر دولة إسرائيل في هذا الإطار كضرورة وظيفية داخل النظام الدولي، فمن يملك زمام إدارة الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يملك القدرة على ضبط الإقليم بأكمله. المسألة لا تتعلق بإسرائيل كدولة فقط، بل بوظيفتها بوصفها عقدة مركزية لإدارة التوتر ومنع تشكّل مشروع عربي أو إسلامي جامع.
ولهذا، فإن المعسكر الأول في الإقليم، رغم تناقضاته الظاهرة، يتقاطع ضمنيا عند ضرورة بقاء إسرائيل. أما المعسكر الثاني، فتنقسم مكوناته حول وجود إسرائيل ذاته. هذه المفارقة تجعل أي مواجهة غير محسوبة خطرا مضاعفا، لأن جزءا من اللاعبين يكون متداخلا وظيفيا مع المعسكر المقابل، بما يؤدي إلى تدمير الذات قبل الخصم.
ومن ثم يصبح سؤال: من يقف معنا فعليا؟ سابقا على سؤال: كيف نواجه؟ لأن تداخل المواقع داخل الفريق الواحد يحوّل أي مواجهة إلى استنزاف ذاتي طويل الأمد.
سؤال الحرب والبناء
مع الإقرار بالبعد العقدي والأخلاقي للمواجهة، يظل السؤال الجوهري متعلقا بكيفية إدارة الصراع ضمن مشروع وبنية قادرة على الاستمرار والتراكم. هذا ليس دعوة للتثبيط، بل إعادة تفكير في البناء، وفي صناعة جيل وجيش ومؤسسات قادرة -حتى إن لم تحسم الصراع- على أن تغيّر مساره لصالحها
من هنا، يصبح اتخاذ قرار الحرب أو المواجهة مسألة تتجاوز النوايا والشعارات. ومع الإقرار بالبعد العقدي والأخلاقي للمواجهة، يظل السؤال الجوهري متعلقا بكيفية إدارة الصراع ضمن مشروع وبنية قادرة على الاستمرار والتراكم. هذا ليس دعوة للتثبيط، بل إعادة تفكير في البناء، وفي صناعة جيل وجيش ومؤسسات قادرة -حتى إن لم تحسم الصراع- على أن تغيّر مساره لصالحها.
المنظومات القائمة ليست أبدية، لكن الخطر الحقيقي يكمن في انهيار منظومة الغرب دون وجود بديل جاهز لدى العرب والمسلمين. في هذه الحالة، لا يولّد الفراغ تحررا، بل يفتح المجال لمنظومات أكثر قسوة.
لماذا مصر هي المركز.. ولماذا الخطر مختلف؟
تتضح مركزية مصر بوصفها العقدة التي لا يُسمح بانهيارها ولا بتحررها الكامل. وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم في لحظة تاريخية فارقة لم يكن حدثا هامشيا، بل جاء بإرادة شعبية حقيقية، لأنهم جزء من نسيج المجتمع المصري، داخل بنيانه لا على هامشه. وهنا يختلف الخطر جذريا عن حالتي تونس وسوريا.
ففي تونس، يختلف الموقع الجغرافي اختلافا حاسما عن الحالة المصرية، إذ لا تمثل تونس عقدة مركزية في منظومة الممرات الدولية ولا نقطة ارتكاز في ضبط الإقليم، ما جعل أي تحوّل سياسي فيها محدود الأثر إقليميا وقابلا للاحتواء. أما في سوريا، فقد جرى الصراع في سياق تفكك الدولة، وتعدد الفاعلين المسلحين، وغياب الإرادة الشعبية الجامعة، ما حوّل الإسلاميين إلى طرف من أطراف الحرب، لا تعبيرا عن المجتمع، وأفقد التجربة أي إمكانية للتحول إلى نموذج قابل للامتداد.
في مصر، الخطر مختلف لأن أي تحوّل كان سيمس المركز نفسه: قناة السويس، والموقع الجغرافي، والثقل السكاني، والدور التاريخي. لذلك لم يكن مسموحا بتكرار التجربة، لا بالقوة العسكرية وحدها، بل بإعادة إدماج مصر داخل منظومة إدارة الصراع، لا خارجها.
ويتضح هنا أن الخطر لا يتصل بطبيعة الفاعل السياسي بقدر ما يتصل بموقع الدولة داخل هندسة الصراع، وهو ما يجعل الحالة المصرية مختلفة بنيويا عن سائر تجارب التحول في الإقليم.
خاتمة:
من أكتوبر إلى الطوفان؛ يتضح أن الصراع في المنطقة لا يُدار بهدف النصر أو الهزيمة، بل بهدف منع التحول في المركز. تُفكك الأطراف، وتُدار الأزمات، وتُعاد هندسة الجغرافيا، بينما يُمسك الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني بوصفه مفتاح الضبط العام.
السؤال المطروح اليوم ليس كيف نواجه فقط، بل كيف نعيد بناء مشروع وكيان ومنظومة قادرة على الصمود والتراكم؛ لأن لحظة الانهيار قادمة لا محالة، لكن من دون استعداد لن يكون ما بعدها تحررا، بل انتقالا إلى مرحلة أشد قسوة.