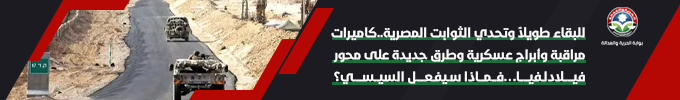بقلم د. عبد المجيد عكروت
لا يمكن قراءة السلوك الإماراتي في الساحتين الإقليمية والعربية بمعزل عن السياق التاريخي العميق للصراعات الكبرى في المنطقة فالتحركات التي نشهدها اليوم في اليمن، وسوريا، وليبيا، والسودان، وفلسطين، ليست مفاجآت عرضية، بل امتداد لتجارب طويلة لعبت فيها القوى الكبرى أدوارًا مشابهة، وانتهت بها السنن السياسية إلى زوال أو تراجع.
أولاً ـ الإمارات والسنن التاريخية في الصراع على النفوذ
في عالم السياسة، لا شيء يحدث عبثًا أو في فراغ هناك سننٌ تتكرّر، وقواعد تتناوبها الإمبراطوريات القديمة والجديدة، من صراعات النفوذ في الأزمنة الغابرة إلى التدخلات الحديثة باسم "الاستقرار" أو "مكافحة الإرهاب". ما من قوة صعدت خارج منطق التاريخ، وما من مشروع تمدد دون أن يدفع ثمنًا باهظًا حين يعاكس منطق الجغرافيا أو يتجاهل نبض الشعوب.
لم يكن التحالف الإماراتي مع الغرب، ولا التطبيع مع إسرائيل، خيارًا اقتصاديًا صرفًا، بل تموضعًا استراتيجيًا يراد منه تثبيت مكان في مشهد تتغير خرائطه، وقد بدا واضحًا أن أبوظبي أرادت أن تكون بوابة هذا المحور الجديد إلى المنطقة، ولو على حساب القضايا المركزية، وعلى رأسها فلسطين، أو استقرار الدول التي مزّقتها تدخلاتها، كما في اليمن أو ليبيا أو السودان.
الإمارات لم تكن استثناءً فقد ولدت في بيئة إقليمية مشبعة بالتنافس الحاد، بين السعودية وإيران وتركيا، وبين أطماع دولية لا تغيب، ومنذ نشأتها ككيان حديث، سعت إلى ما يتجاوز حجمها الجغرافي والديمغرافي، فركبت موجة التحالفات مع الأقوياء، وراكمت النفوذ عبر الوكلاء المحليين، واختارت طريق الأمن على السياسة، والقوة على الدولة، والمصلحة على المبادئ. إنه نمط تكرّر في كتب التاريخ، لكنه لا يصمد طويلًا أمام نواميس التحول والتغيير.
لم يكن التحالف الإماراتي مع الغرب، ولا التطبيع مع إسرائيل، خيارًا اقتصاديًا صرفًا، بل تموضعًا استراتيجيًا يراد منه تثبيت مكان في مشهد تتغير خرائطه، وقد بدا واضحًا أن أبوظبي أرادت أن تكون بوابة هذا المحور الجديد إلى المنطقة، ولو على حساب القضايا المركزية، وعلى رأسها فلسطين، أو استقرار الدول التي مزّقتها تدخلاتها، كما في اليمن أو ليبيا أو السودان.
بالتوازي مع تمدد الدور الإماراتي في المنطقة، أخذ رصيدها الشعبي في التآكل تدريجيًا، ولم يكن ذلك بفعل خصوم أقوياء، بل لأن الوعي الشعبي بات أكثر قدرة على التمييز والمساءلة فحين تتحول بعض المدن إلى ملاذ آمن لأشخاص لا يحملون مشروعًا سوى خدمة مصالحهم، أو مأوى لأسماء مطلوبة أو معزولة من أوطانها، يصبح الأمر أكثر من مجرد موقف سياسي. إنه واقع يعيشه الناس ويشعرون بثقله. المال والنفوذ حين يُستخدَمان لتلميع الوجوه، وطمس الحقوق، وصناعة واقع هشّ، فإنهما لا يصمدان طويلًا أمام عاصفة واحدة تعيد ترتيب المشهد. ولهذا، لا يمكن فهم الحضور الإماراتي بمعزل عن سنن التاريخ التي لا ترحم، فالتاريخ لا يُكتب في اللحظة، بل يُحكم عليه في المآلات، وميزان الوعي العام يبقى أدق من حسابات السلطة والنفوذ.
ثانيًا ـ من اليمن إلى فلسطين.. بصمات إماراتية في كل أزمة
في اليمن:
لقد كان التدخل الإماراتي في اليمن بداية النموذج الأكثر وضوحًا لسياسة خارجية تقودها الرغبة في أن تكون لاعبًا فاعلًا في المنطقة. تدخلت الإمارات بدايةً ضمن التحالف العربي الذي دُعي لدعم الشرعية، غير أن حضورها سُجِّل سريعًا على أنه مختلف عن الهدف المعلن. ففي الوقت الذي كان من المفترض فيه دعم مؤسسات الدولة اليمنية، عمدت الإمارات إلى إنشاء ميليشيات مسلحة موازية خارج إطار الجيش الوطني، وشاركت في تمكين قوى انفصالية، وتدخلت في شؤون المحافظات بإرادات متناقضة مع إرادة الدولة.
هذا التداخل في السياسة اليمنية لم يكن مجرد خروج عن الأدوار التقليدية، بل قاد إلى تفكيك وحدة القرار العسكري والاستراتيجي داخل الدولة اليمنية، وأعطى زخمًا لتقسيم البلاد سياسيًا وجغرافيًا، ومع تصاعد نفوذ المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا في المحافظات الجنوبية والشرقية، ظهرت صورة لتدخل يتجاوز حدود المصلحة المؤقتة إلى مشروع أكثر عمقًا يهدد الاستقرار الوطني.
لقد كان التدخل الإماراتي في اليمن بداية النموذج الأكثر وضوحًا لسياسة خارجية تقودها الرغبة في أن تكون لاعبًا فاعلًا في المنطقة. تدخلت الإمارات بدايةً ضمن التحالف العربي الذي دُعي لدعم الشرعية، غير أن حضورها سُجِّل سريعًا على أنه مختلف عن الهدف المعلن. ففي الوقت الذي كان من المفترض فيه دعم مؤسسات الدولة اليمنية، عمدت الإمارات إلى إنشاء ميليشيات مسلحة موازية خارج إطار الجيش الوطني، وشاركت في تمكين قوى انفصالية، وتدخلت في شؤون المحافظات بإرادات متناقضة مع إرادة الدولة.
وبالتوازي مع ذلك، تأزمت العلاقات الإقليمية الكبرى؛ فالسعودية، التي دعمت تحالف الرياض واستعادة الشرعية، وجدت نفسها في حالة تباين متصاعد مع الإمارات، ليس بسبب اختلاف سياسي عابر، بل بسبب تعارض استراتيجي في الرؤى والمشاريع المستقبلية، ومع ظهور الرؤية السعودية 2030، اتسع هذا التباين في المواقف، حيث أصبحت السياسات الإماراتية تُقرأ في كثير من الأحيان على أنها تعرقل المبادرات التي تُعزِّز دور الدول الوطنية، وتفتح الباب أمام مشروعات أخرى لا تتسق مع التوجهات السعودية.
في ليبيا
دخلت الإمارات إلى ليبيا كطرف داعم لبعض القوى، وعلى رأسها المشير خليفة حفتر، الذي لم يكن إلا وجهًا لانقسام طويل داخل المجتمع الليبي. الدعم الإماراتي له لم يكن سياسيًا فحسب، بل عسكريًا مباشرًا عبر إسناد جوي ولوجستي، ما ساهم في إطالة أمد الحرب وإضعاف فرص الحل السياسي.
وهنا تظهر سنة سياسية معروفة: حين تتدخل قوة خارجية لصالح “أحد اللاعبين” على حساب مؤسسات الدولة ومشروع المصالحة، فإنها تعمّق الفرقة وتزيد من عنف الصراع. الدعم الإماراتي لحفتر أعاد إنتاج نموذج “الحرب بالوكالة” الذي تكرر في اليمن أيضًا، حين أصبحت الدعم الخارجي لميليشيات وانتقاليين أداة لإطالة أمد النزاع بدل إنهائه.
الدور هنا ليس مجرد تحالف مع قوة محلية، بل تمكين لخطاب يستند إلى القوة، لا إلى إرادة الشعب، وما فعلته الإمارات في ليبيا يعزز فكرة أن المشروع الذي تقوده ليس مشروع دولة موحدة بل جيوب صراع مفتوحة على التدخلات وزعزعة الاستقرار.
في فلسطين:
شكلت اتفاقيات التطبيع (اتفاقيات أبراهام) بين الإمارات وإسرائيل نقطة مفصلية في تاريخ القضية الفلسطينية. فهذه الاتفاقيات لم تكن مجرد معاهدات دبلوماسية، بل إعادة ترسيم إقليمي لمنظومة العلاقات، حيث وضعت إسرائيل في موقع أقوى في محيط عربي لم تعد فيه القضية الفلسطينية مركزية كما كانت سابقًا. الإمارات بهذا التحالف لم تفتح باب التعاون التجاري فحسب، بل بادرت إلى تنسيق أمني واستراتيجي مع تل أبيب، وهو ما أزعج الحركات الوطنية الفلسطينية التي ترى في هذا التطبيع خيانة لقضيتهم.
الإمارات، بدل أن تعبّر عن تضامنها مع الفلسطينيين، حاولت تمرير خطاب مفاده أن “التطبيع هو باب للسلام”، وهي رسالة مرفوضة من القوى الوطنية التي تعتبر إسرائيل قوة احتلال.
في سوريا
لم تكن الإمارات طرفًا حياديًا في الأزمة السورية كما تُظهر نفسها، بل كانت من أوائل الدول التي تبنّت موقفًا سلبيًا تجاه الثورة السورية منذ لحظاتها الأولى، حين خرج الشعب مطالبًا بالحرية والكرامة، فآثرت الإمارات الوقوف في الظل، وعدم دعم إرادة الشعب السوري في إقامة دولة مدنية ديمقراطية، ومع مرور الوقت، وتحديدًا مع انكسار الثورة عسكريًا في عدد من المواقع، انكشفت النوايا بوضوح، حيث بدأت أبوظبي تنسّق علنًا مع نظام بشار الأسد، الذي تلطخت يداه بدماء مئات آلاف المدنيين. أعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق في 2018، في خطوة صادمة ومرفوضة شعبيًا، تزامنًا مع ضغوط عربية ودولية لعزل النظام سياسيًا.
الإمارات لم تكتفِ بتطبيع سياسي، بل تحوّلت إلى ملجأ لعدد من أركان النظام السوري ومقربيه، بمن فيهم رجال أعمال خضعوا لعقوبات دولية أو كانت لهم أدوار في دعم آلة القمع، وهذا ما حوّل بعض المدن الإماراتية إلى ملاذ آمن للمتورطين في جرائم بحق السوريين، في تحدٍ لمشاعر اللاجئين الذين خسروا أوطانهم وأحبابهم.
وحتى بعد سقوط نظام الأسد، حالت الإمارات دون الاعتراف بالدولة السورية التي أنتجتها الثورة، ووقفت حجر عثرة أمام أي تمثيل حقيقي لإرادة الشعب السوري في المحافل الإقليمية والدولية.
وبعد ذلك، تبنّت أبوظبي خطاب الأقليات، خصوصًا في مناطق مثل السويداء، حيث سعت إلى تقديم نفسها كضامن لحماية الأقليات الدينية، في خطاب يعيد إنتاج رواية النظام ذاته، ويعمّق الانقسام المجتمعي بدل أن يدعم مشروعًا وطنيًا جامعًا.
بهذا النهج، تكون الإمارات قد أفسدت على السوريين فرحة الانتصار في أكثر من محطة، ووقفت ضد إقامة دولة سورية حقيقية تعبّر عن تطلعات مواطنيها، واختارت أن تكون في صفّ القاتل لا القتيل، وفي صفّ الطغيان لا التحرر.
في السودان
أحد أبرز الأمثلة على السياسات الإماراتية في التدخل الخارجي هو دعمها لقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، على حساب الدولة السودانية.
الإمارات وجدت في حميدتي أداة عسكرية صلبة، فتغلغلت في المشهد السوداني، وأعطته غطاء سياسي، ما أعاق مسار الانتقال الديمقراطي، وجعل الصراع الداخلي أكثر دموية. ليس هذا فحسب، بل إن حضور الإمارات في السودان عزّز الانقسامات بدل أن يدعم إرادة الشعب السوداني في بناء دولته المستقرة.
ثالثاً ـ الخطاب الإنساني والسياسي.. الإمارات وامتحان القيم
العالم لا يتغير بالشعارات المجردة، بل بميزان يُفرز من يقف إلى جوار الإنسان، ومن يقف ضدّه، مهما كانت الرايات التي يرفعها. نحن اليوم أمام قوتين تتصارعان في وجدان الشعوب: قوى تطالب بالعدالة، وتدافع عن الكرامة والحق في الحياة، وأخرى تُغلّف مصالحها الضيقة بلغة الاستقرار، بينما هي في حقيقتها تعمّق القمع، وتشرعن الانتهاك، وتطيل أمد الأزمات.
الإمارات، حين اختارت أن تدعم أنظمة دموية أو مليشيات مسلحة خارج إطار الدولة، لم تكن فقط تتدخل في سيادة الدول، بل شاركت فعليًا في انتهاك حقوق الإنسان. من مشاهد السجون السرية في عدن التي وثّقتها منظمات دولية، إلى المقابر الجماعية في ليبيا، ومن مجازر الفاشر في السودان إلى اختطاف القرار السياسي في اليمن، تتراكم مشاهد لا تسقط بالتقادم، وقد رصدتها الكاميرات ووثقتها تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية.
إن التقديرات الواقعية تشير إلى أن الدور الإماراتي مرشح للتراجع في المستقبل القريب، لا بفعل مؤامرة، بل استجابة طبيعية لانتهاء صلاحية أدوات واصطفافات تجاوزها الزمن، وكما بدأ الدور الإماراتي بوظيفة تخدم مصالح دول كبرى، فإنه ليس من المستبعد أن يتم الاستغناء عنه متى ما اقتضت التحولات الدولية ذلك، خاصة إذا بات عبئاً على من رعوه، أو أصبح تجاوزه ضرورة لتهدئة شركاء أقوى في معادلة النفوذ، وقد تكون بداية هذا التحول في ملفات محددة، كاليمن أو السودان، لكن أثره سيمتد نحو كامل الدور الإقليمي.
حين يقف شعبٌ أعزل مطالبًا بحقه في تقرير مصيره، وتواجهه أدوات إماراتية بالسلاح والتصفية والاغتيال، فإن ما يحدث لا يمكن اعتباره "تدخلًا سياسيًا"، بل جريمة ضد الإنسانية. هذه السلوكيات لا تُمحى من ذاكرة الشعوب، ولا من سجلات المحاكم الدولية التي تتسع يومًا بعد آخر لملاحقة من تجاوزوا الخطوط الحمراء في التعامل مع كرامة الإنسان.
رابعاً ـ التحولات القادمة ومأزق الدور الإماراتي.. نحو نهاية أدوار لا تتجدد
في الأعوام القليلة القادمة، يتجه الإقليم والعالم نحو تحولات استراتيجية متسارعة، ليس بفعل رغبة الأطراف، بل نتيجة طبيعية لتغير موازين القوى وتآكل أدوات النفوذ التقليدية. القوى التي راهنت طويلًا على التدخلات المباشرة، ودعمت الميليشيات على حساب مؤسسات الدولة، واصطفت خلف التحالفات الأمنية الصلبة، بدأت اليوم تواجه واقعًا مختلفًا يتطلب مراجعة جادة.
الإمارات، كواحدة من أكثر الفاعلين الإقليميين حضورًا خلال العقد الأخير، تجد نفسها أمام هذا التحول. فالنموذج الذي اعتمدته لم يعد قابلًا للاستمرار كما كان. المجتمع الدولي يعيد ضبط أولوياته، والسياسات الإقليمية تتحول من منطق الهيمنة إلى التوازن، ومن خيار الحسم إلى خيار التهدئة وإعادة بناء الدول على أسس الاستقرار الحقيقي، لا عبر وكلاء السلاح.
التحالف مع قوى كـ"حميدتي" في السودان، و"حفتر" في ليبيا، ورعاية شخصيات مطلوبة أو مثيرة للجدل، وإيواء أطراف من النظام السوري بعد الثورة، والدفع بخيارات تقسيمية في اليمن، جميعها صارت عبئًا سياسيًا لا أداة نفوذ. حتى اتفاقات التطبيع، التي كان يُعوّل عليها لفتح بوابات النفوذ الاستراتيجي، لم تُنتج مظلة حماية فعلية، بل أوجدت ارتدادات سياسية وحسابات جديدة في المنطقة.
من هنا، فإن التقديرات الواقعية تشير إلى أن الدور الإماراتي مرشح للتراجع في المستقبل القريب، لا بفعل مؤامرة، بل استجابة طبيعية لانتهاء صلاحية أدوات واصطفافات تجاوزها الزمن، وكما بدأ الدور الإماراتي بوظيفة تخدم مصالح دول كبرى، فإنه ليس من المستبعد أن يتم الاستغناء عنه متى ما اقتضت التحولات الدولية ذلك، خاصة إذا بات عبئاً على من رعوه، أو أصبح تجاوزه ضرورة لتهدئة شركاء أقوى في معادلة النفوذ، وقد تكون بداية هذا التحول في ملفات محددة، كاليمن أو السودان، لكن أثره سيمتد نحو كامل الدور الإقليمي.
*دكتوراه في الاقتصاد والقانون